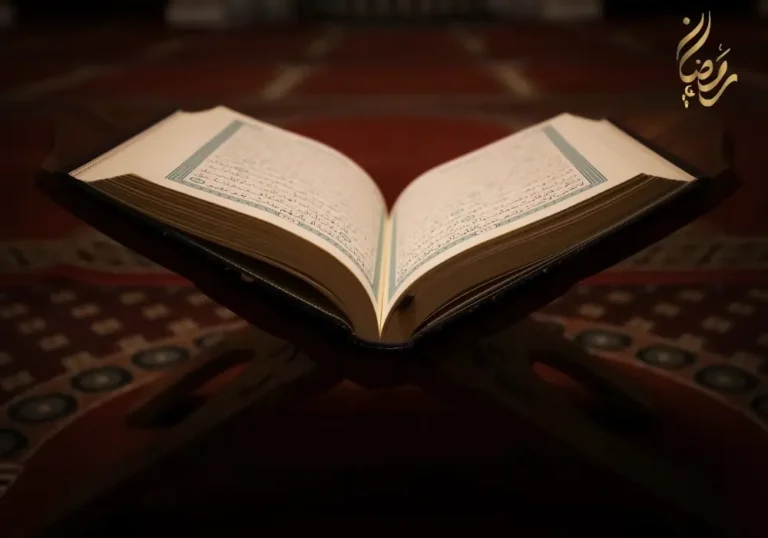حينما يحل اليقين
الطاعة المطلقة لله في العبادات وأهميتها في حياة المسلم
بالأمس كنا في شهر رمضان، حيث فرض الله علينا الصيام ومنع تناول أي مفطرات خلال النهار تعبّدًا له. واليوم، في أول أيام شهر شوال، يحرّم علينا الصيام، امتثالًا لأمر الله الذي شرّع لنا الإفطار لنعبده من خلال تناول ما كان محرّمًا علينا بالأمس، ولذلك سُمّي هذا اليوم بعيد الفطر. فكما فرض علينا الصيام، نهانا عن صيام هذا اليوم، مما يعكس مبدأ الطاعة المطلقة لله.
يقول الله تعالى:
“والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم” (التوبة: 71).
استمرارية العبادة في جميع الأوقات:
خلق الله الإنسان لعبادته، وجعل جميع الأوقات—سواء دقائق، أو ساعات، أو أيامًا، أو أشهرًا—فرصة للتقرب إليه. قال تعالى:
“وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” (الذاريات: 56).
كما جعل الليل والنهار وسيلة لذكره وشكره:
“وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا” (الفرقان: 62).
وقد أمر الله عباده بالاستمرار في طاعته حتى نهاية الحياة:
“واعبد ربك حتى يأتيك اليقين” (الحجر: 99).
تنوع العبادات بين الواجب والمستحب:
الصيام الذي كان بالأمس فرضًا أصبح اليوم محرّمًا، وسيصبح غدًا مستحبًا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
“من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر” (مسلم: 1164).
وبينما انتهى رمضان، فقد بدأت أشهر الحج اليوم، وهي فرصة جديدة للتقرب إلى الله، كما قال تعالى:
“الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونِ يا أولي الألباب” (البقرة: 197).
قيام الليل عبادة مستمرة بعد رمضان:
رغم انتهاء رمضان، فإن قيام الليل لا ينقطع، بل هو سُنة نبوية مستمرة التزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال الله تعالى:
“والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا” (الفرقان: 64).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على قيام الليل، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حين قال له النبي:
“نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل”، فكان عبد الله بن عمر بعدها يحرص على القيام (البخاري: 1105).
كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وساوس الشيطان التي تمنع الإنسان من قيام الليل، فقال:
“بال الشيطان في أذنه” لمن نام ولم يقم للصلاة (البخاري: 1093، مسلم: 774).
ثبات الأحكام الشرعية في كل زمان:
الأوامر الإلهية لا تتغير بحسب الزمان، فما كان محرّمًا في رمضان يبقى محرّمًا بعده. فالمعاصي كترك الصلاة، والشرك، والربا، والزنا، والظلم، والغيبة، تبقى من الكبائر سواء في رمضان أو غيره. يقول الله تعالى:
“والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا” (الفرقان: 68).
أهمية استغلال الوقت في طاعة الله
الوقت نعمة عظيمة، ويجب على الإنسان أن يستثمره في الطاعة. ولذلك، نجد في القرآن الكريم قسمًا بالوقت مثل:
“والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” (العصر: 1-3).
وحذّر الله تعالى من إضاعة العمر في الغفلة، حيث يقول:
“أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير” (فاطر: 37).
كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيُسأل عن عمره يوم القيامة، حيث قال:
“لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه…” (الترمذي: 2417).
استمرارية الطاعة وأثرها في حياة المسلم:
إن الالتزام بأوامر الله والاستمرار في عبادته ليس مقصورًا على مواسم معينة، بل هو أسلوب حياة يجب أن يلازم المؤمن في كل وقت وحين. فكما كان المسلم يجتهد في الطاعة خلال شهر رمضان، ينبغي له أن يواصل هذه الطاعات في سائر أيام العام.
يقول الله تعالى:
“إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون” (فصلت: 30).
فالاستقامة على الطاعة بعد مواسم الخير، كرمضان والحج، هي علامة على قبول العمل، إذ أن الله يحب العبد الذي لا ينقطع عن عبادته. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث لم تكن عباداتهم مرتبطة بمواسم معينة، بل كانت دائمة ومستمرة.
أثر العبادة في تهذيب النفس:
العبادة ليست مجرد طقوس يقوم بها الإنسان، بل لها أثر عميق في تهذيب النفس وتقويم السلوك. فالذي تعود على الصيام في رمضان، لا يسهل عليه بعده أن يقع في شهوة محرّمة. والذي اعتاد قيام الليل، لن يجد لذته في السهر على المعاصي. والذي تعوّد على الصدقة، لن يكون شحيحًا عند الحاجة.
وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
“أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل” (البخاري: 6464).
فالمداومة على العمل الصالح، حتى لو كان بسيطًا، أفضل عند الله من كثرة العبادات المؤقتة التي تنقطع بعد فترة قصيرة.
الحذر من الفتور بعد الطاعة:
من الأمور التي يقع فيها بعض المسلمين بعد المواسم الإيمانية، هو التراخي والفتور عن العبادات التي كانوا يقومون بها، وكأنهم كانوا يعبدون رمضان أكثر مما يعبدون الله. وهذا خطر عظيم، فقد قال الله تعالى محذرًا:
“ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا” (النحل: 92).
ولذلك، يجب أن يستمر الإنسان في الطاعة حتى لا يقع في هذا الفتور. ومن الوسائل التي تساعد على ذلك:
1. الصحبة الصالحة: فمن كان حوله أناس يعينونه على الطاعة، كان أثبت على الخير
2. تنظيم الوقت: تخصيص أوقات محددة للعبادة يجعلها جزءًا من الروتين اليومي.
3. المحافظة على النوافل: مثل السنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس، لتبقى الروح متصلة بالعبادة.
4. الاستمرار في قراءة القرآن: فلا يكون القرآن مهجورًا بعد رمضان.
استثمار الأوقات في الطاعة:
الوقت هو رأس مال الإنسان، وهو ما سيُسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
“نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ” (البخاري: 6412).
لذلك، ينبغي للمسلم أن يحرص على استثمار وقته في أمور تعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته، سواء بالعبادات، أو طلب العلم، أو العمل الصالح، أو خدمة الناس.

إن العبادة ليست موسمًا مؤقتًا ينتهي بانتهاء رمضان، بل هي أسلوب حياة دائم. فكما أن الإنسان مطالب بالاستقامة في حياته كلها، فإنه أيضًا مطالب بالمداومة على الطاعات والبعد عن المعاصي في كل وقت.
نسأل الله أن يجعلنا من عباده المداومين على طاعته، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.
الخاتمة: العبودية المستمرة لله
المسلم عبد لله في رمضان وخارجه، وحياته كلها يجب أن تكون مكرّسة لطاعة الله:
“قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين” (الأنعام: 162).
وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في العبادة حتى الموت:
“فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين” (الحجر: 98-99).
نسأل الله أن يوفقنا لطاعته في جميع الأوقات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.